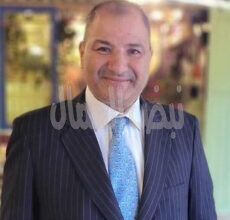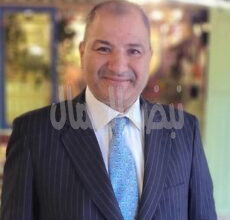محمد عبدالرحمن
٤ نوفمبر ٢٠٢٥
صرحت الدكتورة مونيكا حنا على صفحتها الشخصية بالفيس بوك قائلة : بصفتى باحث مصـرى فى علم الآثار والحضارة القديمة—وأخصّ فى دراسة مصر القديمة—
ضروري أشارك معاكم رأي علمى واضح وصريح عن ظاهرة منتشرة دلوقتى على الإنترنت: إنّ فى بعض صانِعى المحتوى الرقمي بيحتفلوا بـ «نظريات» أو تفسيرات لـ الحضارة المصرية القديمة كأنها علم معتمد، لكن فى الحقيقة كتير من دى بتقع تحت ما يُعرف بـ Pseudo‑archaeology (علم-زائف فى علم الآثار) أو Pseudoscience – اللي للأسف اتسرب لكاتب سيناريو حفل افتتاح المتحف الكبير بدون اي مراجعة علمية او اثرية.
وده يطرح سؤال مهم: إزاي نفتح مجال المعرفة من غير ما نسيب العلم الحقيقى يتهشّم؟
أولًا: ما هو «العلم الزائف» فى سياق الحضارة المصرية؟
• مصطلح «pseudo-archaeology» بيشير إلى تفسيرات أو ادّعاءات عن الماضي الأثري لا بتتّبع المنهج العلمى، أو ما ليهاش دلائل قابلة للتحقق، وبتعتمد غالبًا على تكهنات أو قراءات بديلة أو نظريات المؤامرة.
• أمثلة معروفة فى مصر: مثلاً Orion Correlation Theory اللى بتقول إن مواقع أهرامات الجيزة مصمَّمة حسب نجوم حزام أوريون، لكن النظريّة ديه لم تثبُت فى الأوساط الأكاديمية ولحد دلوقتي بتعتبر خيال علمي.
• أو ادّعاءات عن تكنولوجيا فائقة لمصر القديمة أو وجود حضارات سابقة خارقة، أو أن الأهرامات كانت «محطات طاقة» أو أن الفضائيين هم اللى بنوها، وهى كلها أمثلة تتحوّل إلى «رواية جذّابة» لكن مش قائمة على أدلة علمية.
تانيًا: ليه ده خطر أو محتاج انتباه؟
• لأن المحتوى ده ممكن يُشوّش على الجمهور العام ويفتح الباب لنشر معلومات غير صحيحة أو مبالغ فيها عن حضارتنا، مما يقلّل من قيمة البحث الأكاديمى أو يحوله لكوميديا بدل بحث علمي حقيقي.
• لما المتاحف أو المراكز الثقافية أو القنوات الرسمية تشارك أو تروّج لمثل هذه النظريات من دون تدقيق، ده ممكن يُضعف مصداقية المؤسسات العلمية ويخلق ارتباكاً معرفي لمعلومات علمية موجودة بشكل ضغيف جداً باللغة العربية.
• المعرفة مفتوحة، وكل شخص حرّ إنه يسأل، لكن لازم يكون فيه تمييز بين السؤال والنقد العلمى من جهة، وبين الترويج لروايات غير مدعّمة من جهة تانية.
ثالثًا: رؤيتى كمصرىة وأستاذ مساعد في الأثار المصرية لموقف المؤسسات (زي المتحف الكبير أو المجلس الأثلى للأثار)
أنا أعتقد إنه:
1. مش لازم «نقفل الباب» تمامًا على النقاش أو الأسئلة الغريبة أو البديلة — بالعكس، الشكّ العلمى والتساؤل هو جوهر المعرفة.
2. لكن فى نفس الوقت، المؤسسة (المتحف، هيئة الآثار، اقسام الاثار في الجامعات) لا ينبغي إنها تدعم أو تُروّج لنظريات لم تثبت بعد، أو تُعرضها كأنها «حقيقة مثبتة». هذا تأدية غير مهنية لها وللجمهور.
3. لازم يكون فيه تمييز واضح عند الجمهور: «هذا بحثٌ أولى / هذه فرضية / هذا غير مثبت بعد»، بحيث لا تختلط الأمور.
4. المحتوى المؤسسى لازم يخضع للتدقيق العلمى، ويُبسط الحقيقة للمجتمع — مثلاً، أن نبلغ الناس إنّ «هذه النظرية مثيرة ولكن لم تُدعَم بأدلة كافية»، بدل ما نعرضها وكأنها «معلومة مؤكّدة» وخصوصاً في افتتاح درة التاج، المتحف المصري الكبير.
5. من المفيد أن يكون فيه تعليم أو برامج توعية فى المتحف أو على الإنترنت تشرح للمشاهد: كيف نعرف المعلومة الأثرية؟ ما هى المصادر؟ وما هى طريقة التأكد؟ حتى الناس تكتسب «محو أمية علمية» فى الآثار.
رابعًا: كلمات أخيرة موجهة لجمهور صانِعى المحتوى والمهتمين
• لو إنت صانع محتوى أو متابع بحب الحضارة المصرية، شجّع الفضول ولكن كن صادق مع نفسك ومع جمهورك: هل ما تقدّمه مبنى على بحث؟
هل فيه أدلة؟ أو هل هو مجرد تكهّن أو رواية مثيرة؟
• اسأل: من أين جاءت المعلومة؟ هل فى ورقة بحثية محكمة في دورية علمية ليها معامل تأثير ولا كتب ماتزوقيني يا ماما عشان كاتبها واحد مهندس – مع كام احترامنا للمهندسي؟ هل الأُثُر أو المصادر المكتوبة تدعمها؟ هل علماء متخصصون فى مصر القديمة ناقشوها؟
• احترم أن البحث العلمى قد لا يكون مثيرًا مثل الرواية السريعة، لكن متانة الدليل وأمانة النقل أهم بكتير من «ترند» أو «مشاهدات».
• ونصيحة لمتابعى المتاحف أو المهتمّين: ماتشوفوش المتحف كأنه «عرض مسلّي» فقط، بل كمكان للتعليم والتثقيف والتفاعل مع الماضي، لكن لا يجب التضحية بالعلم عشان نعمل عرض مبهر وتسويق للمتحف.